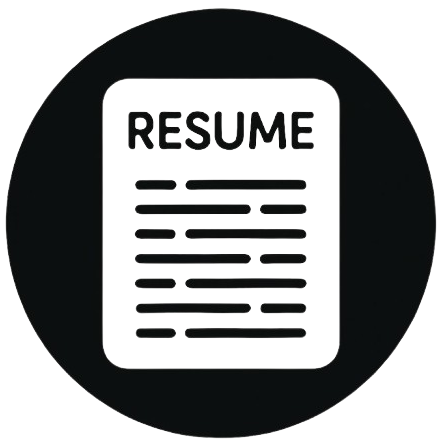في بعض الفصول، تحوّل المعلم إلى مراقب، والطالب إلى ناقل، وتقدّمت الشاشة خطوة… وتراجع العقل خطوتين.
لم نرفض الذكاء الاصطناعي يوماً، لكننا نخشى أن يبتلع الدور الإنساني، أن يصبح الطالب مُنتِجاً لنصوص مثالية… بلا أثر لروحه، وأن يتحوّل المعلم إلى مُقيِّم للشكل… لا للحضور العقلي.
إن أخطر ما يحدث ليس أن نرى واجبات أنيقة، بل أن نحتفل بها ونحن نعرف – أو نتجاهل – أن العقل الذي يفترض أن ينتجها كان غائباً.
في دراسة لجامعة Stanford عام 2023، تبيّن أن استخدام الأدوات الذكية سرّع إنجاز الواجبات، لكنه خفّض القدرة على صياغة رأي مستقل.
وفي تقرير UNESCO لعام 2024، جاء التحذير واضحاً: «المعرفة التي لا يرافقها توجيه بشري تتحوّل إلى سطحية»، وتنتج جيلاً من «المستخدمين الممتازين… لا المفكرين المستقلين».
ما أظهرته الدراسة يعد جرس إنذار: كل دقيقة نوفّرها للطالب عبر الأداة قد تكون دقيقة نخسر فيها نمو عقله.
اليوم، يسأل الطالب الأداة الذكية عن رأيها… ويقدّمه كما هو. وعندما يُطلب منه شرحه، يتلعثم أو ينسحب أو يعترف: «ما أعرف… بس هذا اللي طلع معاي».
هنا تبدأ الكارثة: النص يعلو… وصاحبه يختفي. تتحول الحصة الدراسية من مختبر للتفكير إلى صالة عرض لمنتجات رقمية، يمرّ المعلم بينها كما يمرّ الزائر في معرض، معجباً بالألوان… غير سائل عن الرسّام.
إن أخطر ما يحدث أن تُستبدل صناعة الفكر بصياغة التعبير، وأن نحكم على الطالب من جمال النص لا من حضور عقله فيه. التعليم ليس في كم أنجز الطالب، بل في كم فكّر وهو ينجز.
والسؤال الأعمق: هل نُربّي عقولاً قادرة على إنتاج أفكارها، أم نُدرّب أصابع سريعة على إدخال الأوامر الصحيحة في أداة ذكية؟
الحل ليس في محاربة الذكاء الاصطناعي… بل في ترويضه:
-
دمج التقييم الشفهي مع الكتابي، بحيث لا يكتمل أي واجب دون أن يشرحه الطالب بصوته.
-
تصميم مهام مفتوحة التفكير، تربط المعرفة بحياة الطالب ومواقفه الشخصية.
-
تدريب المعلمين على قراءة «بصمة الطالب» في كتاباته، ورصد الفجوة بين ما يكتبه وما يقوله.
-
ترسيخ ثقافة أن الأداة مُساعِدة، لا بديلة عن العقل.
فالآلة – مهما بلغت دقتها – بلا ضمير، والطالب إن فقد صوته صار تابعاً لا متعلماً.
فيا منظومة التعليم، لا تسألوا فقط عن مستوى الواجبات، بل ضعوا سؤالاً واحداً قبل أي تقدير:
هل كتب الطالب… أم كتب عنه؟