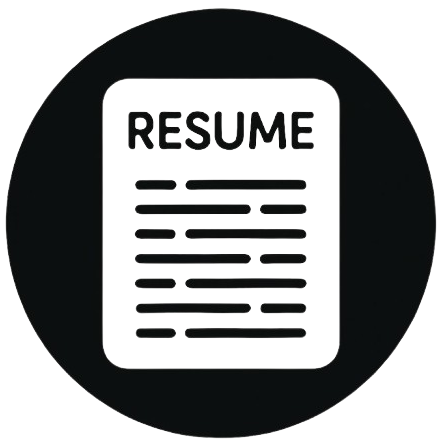في صباح أول يوم دراسي، قال المعلم لطلابه: “كل عام وأنتم بخير وعوداً حميداً”، فإذا بأحدهم يرد: “أتمنى أن أموت ولا أعود للدراسة!” وهذه ليست قصة خيالية، بل حكاية حقيقية أخبرني بها صديق لي، معلم في المرحلة الثانوية، ليعكس صدمة المشهد وجرس الإنذار الذي دقّ في قلبه قبل أذن طلابه.
جملة عابرة؟ ربما…لكنها صفعة على وجه منظومة التعليم والأسرة معاً. إنها ليست مجرد نكتة أو تعبير عن الملل، بل صرخة مكتومة تكشف علاقة الطالب بالمدرسة: علاقة خوف، أو كره، أو شعور بالاغتراب.
هذه ليست أول مرة نسمع فيها مثل هذا التذمر، لكن الخطير أن تصبح المدرسة رمزاً للعقوبة لا بوابة للحياة. في كتب التاريخ نقرأ عن المعتصم بن هارون الرشيد، الذي قال يوماً لأبيه بعد وفاة غلامه: “مات واستراح من الكتاب“، فحرمه الرشيد من الكتّاب وصار أميّاً. كلمة كره للتعليم غيّرت مصير خليفة عباسي كامل…فكيف بكلمة طالب في القرن الحادي والعشرين؟
تشير تقارير اليونسكو إلى أن أكثر من %30 من الطلبة عالمياً يعانون من “قلق المدرسة” ويفكرون في الهروب منها، بل إن بعض الدراسات تربط بين كره المدرسة وانخفاض الدافعية مدى الحياة.
التعليم الذي يبدأ بكره قد ينتهي بجيل يرى المعرفة عبئاً لا فرصة. وحين يفقد الطالب شغفه في أول يوم، نكون قد خسرنا نصف المعركة قبل أن تبدأ.
لكن المسؤولية لا تقع على المدرسة وحدها؛ (فاليد الواحدة لا تصفّق). البيت الذي لا يتحدث عن العلم إلا وقت النتائج، ولا يزرع في أطفاله شغف السؤال والاكتشاف، يصنع تلقائياً طالباً يرى المدرسة سجناً مؤقتاً ينتظر الفرج منه. والمعلم الذي يكتفي بتلقين الدروس دون أن يفتح حواراً أو يربط المعرفة بالحياة يزيد الفجوة عمقاً. إن البيئة التعليمية شبكة مترابطة: الأسرة تغرس الدافع، والمدرسة تصقله، والمجتمع يحتفي به. إن اختلّ ضلع واحد، تعطلت المنظومة كلها.
تخيلوا أماً تجهّز حقيبة ابنها في الصباح، وتضع فيها حلمها أن تراه ناجحاً، بينما قلبه يهمس: “ليتني لا أذهب“. وتخيلوا أباً يوصله إلى باب المدرسة، يظن أنه أرسله إلى مستقبل أفضل، فيما عيني الطفل تبحثان عن مخرج للهروب. هذا التناقض بين ما نتمناه لهم وما يشعرون به هو جرح لا يلتئم إلا إذا اجتمع البيت والمدرسة على علاجه.
الحل ليس في فرض العودة بالقوة…بل في إعادة تعريف العودة ذاتها.
– أن يصنع البيت أجواء تشجع الطفل على حب التعلّم قبل حب الدرجات.
– أن تتحول المدرسة إلى مساحة حوار وتجربة لا مجرد مكان لتلقّي التعليمات.
– أن يشعر الطالب أن صوته مسموع وأن معاناته مفهومة، لا أن يُوبَّخ على كل شكوى.
– أن تتحول بداية العام إلى احتفال بالمعرفة لا بموعد الاختبارات.
إن الطالب الذي يتمنى الموت عند سماع الجرس ليس بحاجة إلى جدول حصص جديد، بل إلى سبب جديد ليعيش يومه الدراسي.
فالسؤال الحقيقي ليس: “متى نعيد أبناءنا إلى المدرسة؟” بل: “كيف نعيد المدرسة إلى أبنائنا؟“