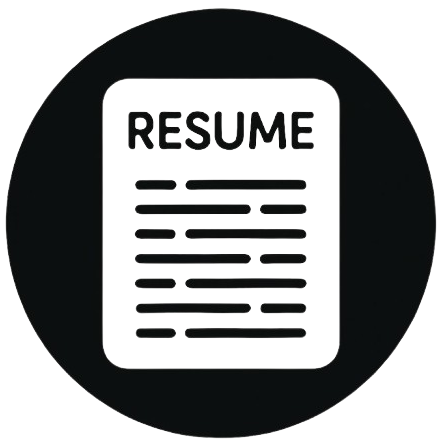ليست المشكلة في العودة…بل في الوهم الذي نعلّقه عليها. نعود بعد الإجازة بوجوهٍ أكثر نشاطاً، ونرتّب الحقيبة والجدول، ثم نُفاجأ أن ما أرهقنا قبل التوقف ما زال في مكانه ينتظرنا. كأننا نريد من بداية الأسبوع أن تفعل ما لم نجرؤنحن على فعله: أن تُنقذ المعنى من العادة.
تقول لنا أبحاث “أثر البداية الجديدة” إن العلامات الزمنية—كبداية أسبوع أو شهر أو سنة—تمنح الناس دفعة نفسية مؤقتة نحو سلوكيات طموحة، لأنهم يشعرون أنهم فصلوا “ذواتهم القديمة” عن “ذواتهم الجديدة”. هذا ما وثّقته دراسة Dai وMilkman وRiis (2014) عبر دلائل سلوكية متعددة مثل زيادة الميل لبدء أهداف صحية وقرارات طموحة عند هذه العلامات. لكن الدفعة وحدها لا تكفي؛ إنها شرارة، والشرارة لا تتحول نارًا دافئة إذا عدنا إلى تفاصيل اليوم نفسه بعاداتنا نفسها.
ثم تأتي الحقيقة التي لا يحبها الحماس السريع: التغيير يحتكم للزمن. بحث تكوين العادات في الحياة اليومية ( Lally et al., 2010 ) وجد أن الوصول إلى تلقائية سلوك جديد يستغرق في المتوسط نحو 66 يوماً، وبمدى واسع قد يمتد من 18 إلى 254 يومًا وفق طبيعة العادة والشخص. لهذا ينهار كثيرٌ من “برنامج العودة” في أسبوعين؛ نحن نطالب النفس بحصاد موسمٍ كامل ونحن لم نزرع إلا أياماً، ثم نُحمّلها فشلًا ليس فشلها.
وهنا يجيء درسٌ صغير حول لغة الهدف. تجربة واسعة على قرارات السنة (Oscarsson et al., 2020) بيّنت أن من اختاروا أهدافاً “اقترابية” تُعرَّف بما سيُبنى كانوا أكثر نجاحاً من أصحاب الأهداف “التجنبية” التي تقوم على المنع فقط ((58.9%مقابل 47.1%، وقال نحو 55% ) إنهم حافظوا على قراراتهم بعد عام. كأن العودة تحتاج هدفاً يُشبه البناء لا المطاردة، ويُشبه الرحمة لا جلد الذات.
لهذا، العودة التي تُصلح ما قبلها لا تبدأ من الباب…بل من الداخل. أن تختار عادة واحدة قابلة للحياة بدل خمسة وعودٍ تُرهقك. أن تُسكنها في توقيت ثابت من يومك حتى لا تتحول إلى نقاش يومي مع الإرادة. أن تُخفف شيئاً كان يسرق نومك وهدوءك باسم “الضرورة”، أو تعيد ترتيب علاقةٍ تستنزفك باسم “الذوق”.
نحن لا نحتاج عودةً أنيقة في المظهر…ونفس النسخة القديمة في الجوهر. نحتاج عودةً تتواضع في البداية، وتصرّفي الاستمرار، وتُدرك أن إصلاح ما قبلها لا يتم بخطابٍ كبير، بل بخطوةٍ واحدة تُكرَّر بصدق حتى تصبح طريقاً.